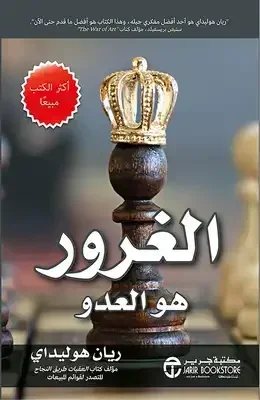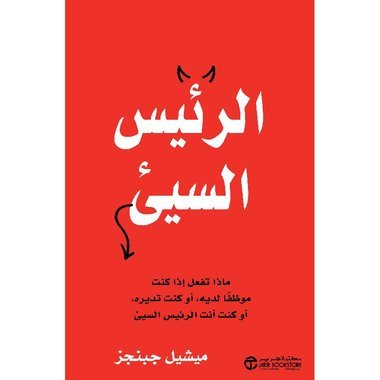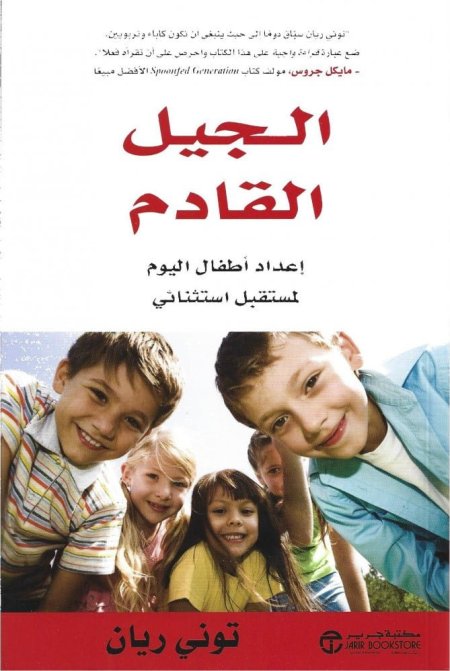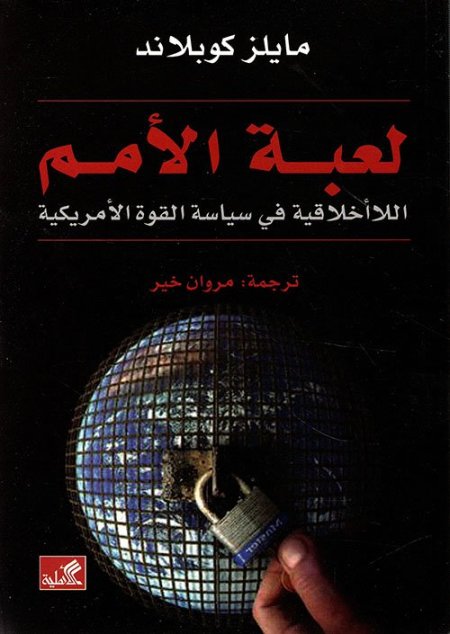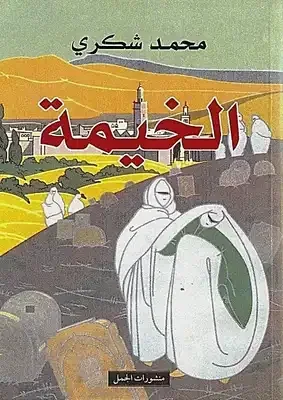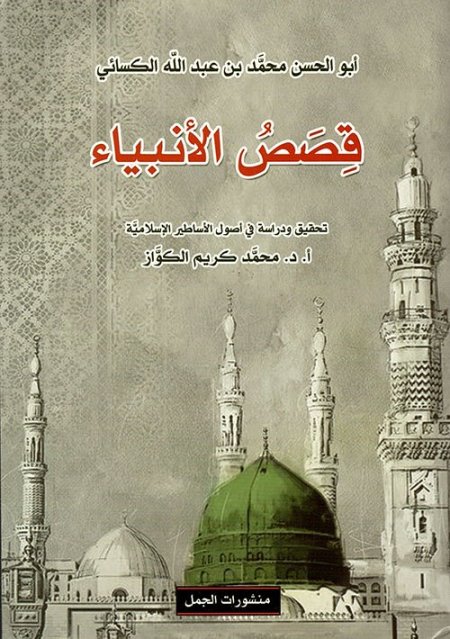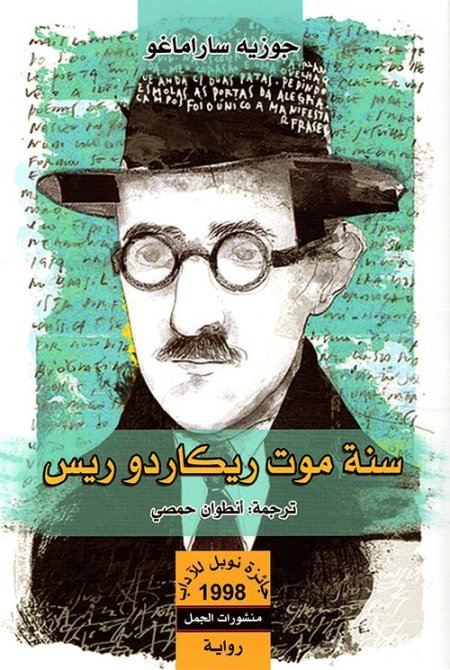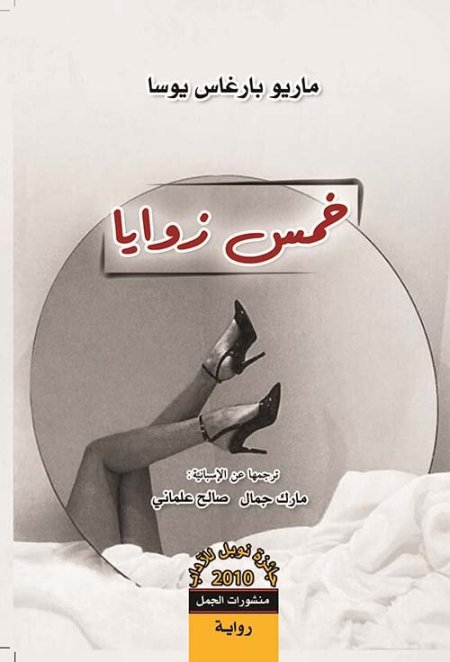في العام 1907، كلف الجنرال دوبيلي ماسنيون القيام بمهمة تنقيبية عن الآثار جنوب بغداد، وقد وصل ماسنيون إلى بغداد منفصلاً في بعثة آثارية تبحث عن قصر الأخيضر جنوب كربلاء، وكان عمره خمسة وعشرين عاماً، فعاش حياة متقشفة، متخفياً بملابس ضابط تركي، ومحميا من قبل العالمين محمود شكري الآلوسي والقاضي علي نعمان الآلوسي. وبعد أن ذهب ماسنيون في غارة الصحراء إلى الجنوب من بغداد للبحث عن قصر اللخميين قصر الأخيضر، رفض أحد الفرنسيين دفع كفالة مستحقة عليه بتحريض من مجموعة من الموظفين الرسميين، فاشتبه بماسنيون من قبل أحد الضباط الأتراك، وألقي القبض عليه بتهمة التجسس والاشتراك بالمؤامرة الماسونية على السلطان عبد الحميد، وعذب وحكم عليه بالموت، واقتيد عبر سفينة في دجلة إلى بغداد مارا من طاق كسرى حيث يرقد هناك الصحابي سلمان الفارسي الشاهد المسيحي على ولادة الإسلام، وفي السجن وعبر القمرة الصغيرة التي تفصله، رأى ماسنيون حمامة محنية تهدل فوق شجرة نخيل، ومن ثم أخذت تهدل بصوتها، وبعد صمت قليل أدرك حقيقة العفو وهي تخرج عبر التعويذة التي حطمها، وتخرج عبر الاسم الذي تلفظه وهو الحلاج، لقد أدرك ماسنيون وهو يمر من الطاق، وعبر مرآته الداخلية، الغريب الذي زاره، مثلما زار قبل سبع سنوات هويسمان، الروائي الفرنسي الذي شهد ماسنيون موته قبل مجيئه إلى بغداد، فاختفى الغريب وراء ملامحه ووقف الكفن الشفاف بينهما وهو يتقزح أمام عبارته الخلاقة، لقد تعرض ماسنيون إلى تحول روجي كبير، بينما كان آل الآلوسي يبذلون جهداً كبيراً لإنقاذه وكفالته أمام حازم بك.
وبعد أن تمكن علي الآلوسي ومحمود شكري الآلوسي من كفالته وإطلاق سراحه، عاد إلى منزل الآلوسي لمداواته وشفائه ورعايته زالت جميع أعراض التعذيب عنه، فقام بمرافقته حتى بلغ مكاناً آمناً، ومنحاه خاتماً مكتوباً عليه (عبده... محمد ماسنيون)، ومن هناك رافقه الأب الكرملي إلى سوريا، ليذهب الكرملي إلى روما وماسنيون إلى باريس. وتبتدأ هذه الرسائل منذ وصول ماسنيون إلى باريس ولا تنتهي إلا بموت الكرملي، وهي موجودة في دار المخطوطات العراقية في بغداد.
وتظهر أهمية هذا الرسائل انطلاقاً في كونها تكشف بشكل واضح وصريح عن العلاقات الثقافية والفكرية والمعرفية بين المثقفين العرب والمستشرقين في الثلث الأول من القرن العشرين، وتبين على نحو فعال الآليات التي تنتظم فيها الخطاب الاستشراقي عبر رسائل واحد من أهم المستشرقين لا في ذلك القرن حسب، إنما منذ تأسيس مدرسة الاستشراق بوصفها المعرفة الخابرة بالشرق من أجل توصيفه وفهمه، والاجتياز عليه وصمه، وتبين على نحو جلي الانشباك الفوري والسريع لهذا الخطاب مع الفعاليات السياسية والممارسات الكولنيالية في المنطقة في الثلث الأول من القرن العشرين، و تبين كيف أن هذا الخطاب لم يكن بأجمعه قائم على الفكرة الكولنيالية في تفضيل المصالح الآنية إنما هنالك المعرفة الخالصة والمستقلة، صحيح أن بعض هذا الخطاب قد استخدم كقوة واسعة النطاق لتبرير الهيمنة والسيطرة والضم من جهة، ومن جهة أخرى قوة للإجتثاث وتفكيك الهوية وتبرير الميكافيلية السياسية، وتدفق الأحقاد، ولكن هنالك وبالموازاة منه كان الخطاب العلمي والثقافي الذي يقارب بين هذه الثقافات والمجتمعات.
وإذ تعلمنا هذا الرسالة، نحن -الجيل الأخير من المثقفين العرب- فإنها تعلمنا بأنه حدث ولمرات متعددة في ثقافتنا الانشباك الصريح مع الغرب لا بوصفه (وجود ثمة) إنما هو حقيقة ثقافية وسياسية، وإن تغيرات هذه الحقيقة فإنها إلى اليوم غير قابلة للنقض والتقويض بوصفها عنصراً من عناصر تشكل ثقافتنا المعاصرة، لكنها ليسن فكرة كلية أو أبدية، إنما يمكننا نقدها وتصويبها، تعلمنا أن ماسنيون استطاع الانفلات من تمركزه العرقي بسبب صداقاته العربية، وتدهشنا هذه العلاقات والصداقات وسعتها أمام الانغلاق الذي يحصل اليوم، والرفض الذي يدعو إلى الأسى.
 الرئيسية
الرئيسية.png) روايات
روايات.png) كتب متنوعة
كتب متنوعة.png) تنمية بشرية
تنمية بشرية كتب تاريخ
كتب تاريخ آداب
آداب.png) فلسفة
فلسفة.png) سيرة ذاتية
سيرة ذاتية.png) كتب مترجمة
كتب مترجمة كتب دينية
كتب دينية كتب اطفال
كتب اطفال علم النفس
علم النفس عرض كل المنتجات
عرض كل المنتجات وصل حديثاً
وصل حديثاً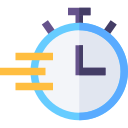 نفدت الكمية
نفدت الكمية الدار الأهلية للنشر والتوزيع
الدار الأهلية للنشر والتوزيع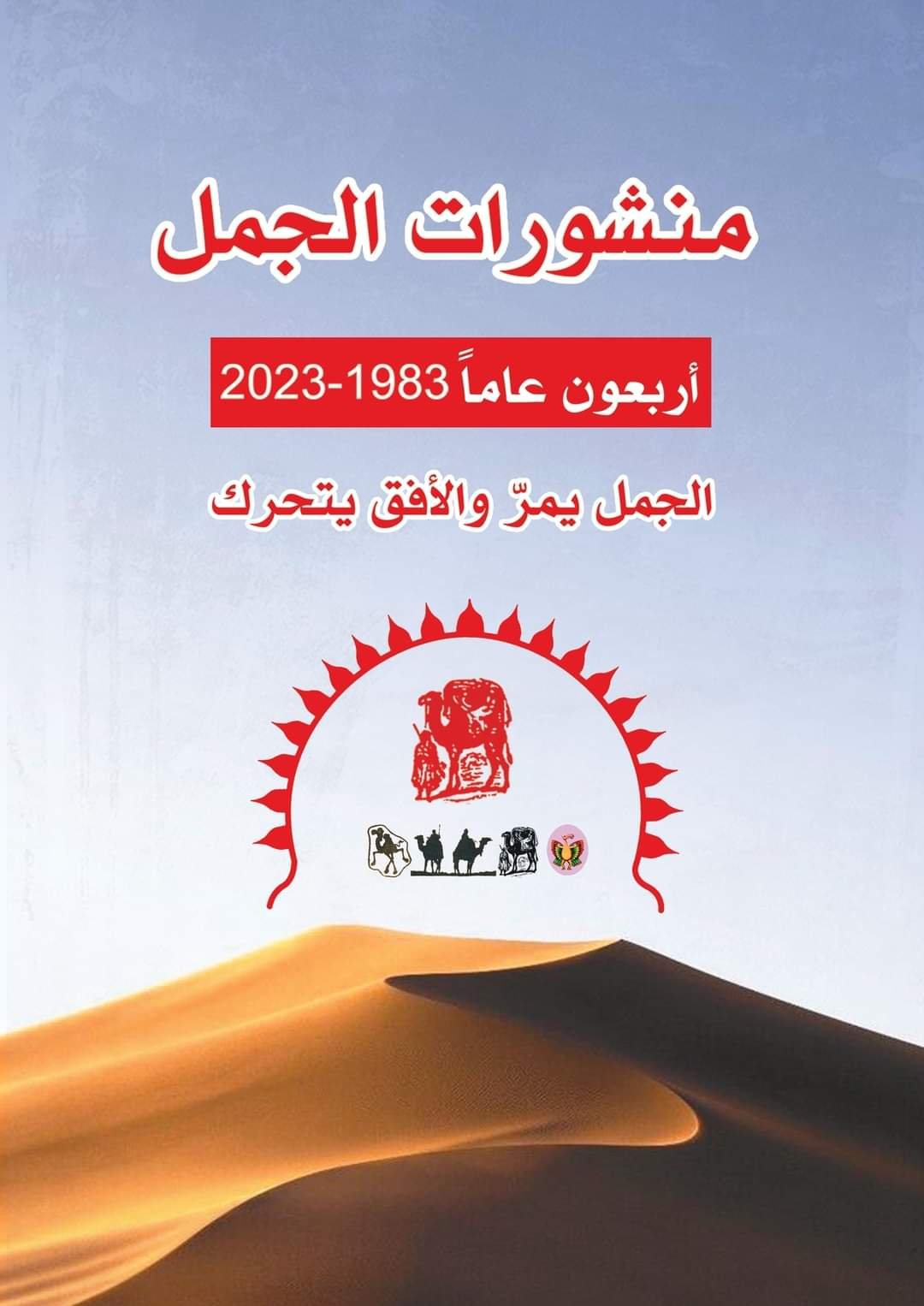 منشورات الجمل
منشورات الجمل كيان للنشر والتوزيع
كيان للنشر والتوزيع نوفل
نوفل دار الساقي
دار الساقي مسكلياني
مسكلياني المركز الثقافي العربي
المركز الثقافي العربي عرض الكل
عرض الكل احصل على تطبيقنا
احصل على تطبيقنا تحدث الينا - واتساب
تحدث الينا - واتساب تابعنا على فيس بوك
تابعنا على فيس بوك